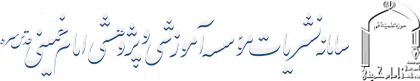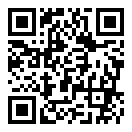الملخص
Article data in English (انگلیسی)
ذروة العبودیة للشیعة الحقیقیین
آیة الله العلامة محمّد تقی مصباح
الملخّص:
هذه المقالة عبارةٌ عن شرحٍ لکلام أمیر المؤمنین (علیه السلام) حول عبودیة الشیعة طبقاً لما تضمّنته روایة نوف البکالی. العبودیة لها معنیان أحدهما خاصّ والآخر عامّ، فهی بالمعنى الخاصّ تدلّ على تلک المناسک والتکالیف التی یجب على الإنسان أدؤها إذعاناً بعبودیته لله سبحانه وتعالى کالصلاة والصیام والحجّ، وأمّا بالمعنى العامّ فهی تدلّ على کلّ عملٍ یقرّب العبد من ربّه تبارک شأنه.
لا شکّ فی أنّ الشیعی الحقیقی هو من یتحلّى بالطاعة الخالصة لله عزّ وجلّ والخشوع عبودیةً له، ومن المؤکّد هنا أنّ بعض الجوارح لها دورٌ أساسیٌّ لا یمکن التغاضی عنه بوجهٍ فی هذا المضمار لکونها تعین العبد على الخلوص فی عبادته، ولا سیما العین والأذن. الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) أکّد على أنّ الشیعة الحقیقیین هم أولئک الذین یخضعون غایة الخضوع ویذعنون تمام الإذعان لله العزیز الحکیم حین عبادتهم، ولو أراد الإنسان أن یکون حرّاً ومالکاً لإرادته فلا بدّ له أولاً من السیطرة على جموح نفسه عن طریق السیطرة علیها وتشذیبها، مثلاً یجب علیه عدم إطلاق العنان لعینه وردعها عن ارتکاب المآثم، إذ إنّ أبسط سبیلٍ لسیطرة الإنسان على نفسه وبناء ذاته هو تحکّمه بعینه وأذنه.
کلمات مفتاحیة: العبادة، الشیعة، عبادة الخاشعین
تصنیف التعاریف التی طُرحت حول الدین وتحلیلها
السیّد محمّد رضا موسوی فراز
الملخّص:
طرحت الکثیر من التعاریف المتنوّعة حول ماهیة الدین من قبل فلاسفة الدین، ومن هذا المنطلق تمّ تدوین هذه المقالة وفق منهج بحثٍ توصیفیٍّ - تحلیلیٍّ، حیث قام الباحث بتصنیف التعاریف المشار إلیها ودراسة وتحلیل بعضها.
الهدف من تدوین المقالة هو إیجاد نظمٍ وانسجامٍ عبر تصنیف مختلف التعاریف التی ذکرت للدین لأجل تیسیر عملیة تحلیلها ونقدها، کما تطرّق الباحث إلى شرح وتحلیل الرأی القائل بصعوبة أو استحالة تعریف الدین، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ إحدى العقبات التی جعلت هذا التعریف شاقاً هی تنوّع الأدیان فی شتّى المجتمعات البشریة. التعاریف التی طرحت حول الدین لم تکن حقیقیةً بمجملها، فمنها ما کان تبلیغیاً. التعاریف الحقیقیة یمکن تقسمها فی الأصناف التالیة: عقلیة، عاطفیة، تطبیقیة، رمزیة، تغییریة، عملیة، دینیة، ترکیبیة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه یمکن طرح تعاریفٍ للدین على أساس المبانی الفلسفیة ومبادئ علم النفس وعلم الاجتماع والفینومینولوجیا، حیث طرح فی کلّ واحدٍ من هذه المجالات العلمیة تعریفٌ أو عدّة تعاریفٍ، وقد تطرّق الباحث إلى شرحها وتحلیلها فی هذه المقالة؛ ومن ثمّ ختمها بطرح تعریفٍ منتخبٍ للدین وقام بشرحه وتحلیله.
کلمات مفتاحیة: تعریف الدین، التعاریف التی طرحت للدین، التعاریف العقلیة، التعاریف العاطفیة، التعاریف التطبیقیة
حتمیة المعاد على ضوء التعالیم القرآنیة
علی محمّد قاسمی
الملخّص:
لا یختلف اثنان فی أنّ المعاد یعتبر واحداً من أهمّ الأصول العقائدیة لدى المسلمین، وهو یحتلّ المرتبة الثانیة بعد التوحید فی القرآن الکریم من حیث عدد الآیات التی تطرّقت إلیه، وهذا الأمر بطبیعة الحال ینمّ عن الأهمّیة الکبیرة للاعتقاد به، إذ إنّ إیمان الناس بوجود معادٍ بعد الممات یضمن تنفیذ الأحکام الدینیة. ونظراً لأنّ أعداء الدین یبذلون قصارى جهودهم للتشکیک بمعتقدات المسلمین وزعزعتها ولا سیّما على صعید عقیدة المعاد التی هی أصلٌ أساسی من أصول الدین، فالضرورة تحتّم علینا العمل على تقویة البنیة الأساسیة لعقائد الشباب ولو بشکلٍ مقتضبٍ بغیة إثبات حتمیة المعاد وبداهته، لذا بادر الباحث إلى دراسة وتحلیل هذا الأمر من زاویةٍ قرآنیةٍ وبأسلوبٍ قرآنیٍّ.
بعض الآیات القرآنیة أکّدت على أنّ تحقّق المعاد یعتبر أمراً حتمیاً لا مناص منه، وبعضها تطرّقت إلى بیان تفاصیله وأحداثه وإثبات بداهته کردٍّ على المشکّکین به والمنکرین له، وعلى هذا الأساس ذکر الباحث عناوین قرآنیة خاصّة له ونقل الآیات التی تضمّنته، حیث صنّف البحث بأسلوبٍ جدیدٍ عبر الرجوع إلى آراء مفسّری القرآن الکریم والتی قام بنقد بعضها.
کلمات مفتاحیة: المعاد، القیامة، الشکّ، الریب، الشبهات، منکرو المعاد
ما هی حقیقة کتاب الأعمال وماذا فیه وکیف یتطایر؟ ومن بیده فصل الخطاب فی یوم القیامة؟
حسن رحمانی
الملخّص:
تطرّق الباحث فی هذه المقالة إلى الحدیث عن جانبٍ من المسائل المرتبطة بیوم الحساب، وسلّط الضوء بالتحدید على حقیقة کتاب الأعمال وأشار إلى بعض أوصافه ومضامینه، وبما فی ذلک اشتراط بعض الأمور لأجل تسجیل الأعمال فیه، کما أشار إلى کیفیة قراءته فی یوم القیامة؛ ومن هذا المنطلق قام بشرح وتحلیل معنى "السرائر" التی هی من محتویات هذا الکتاب، وکذلک وضّح مفهوم "تطایر الکتب"، وفی ختام البحث أشار إلى من له کلمة الفصل - فصل الخطاب - فی یوم القیامة لإصدار الحکم النهائی بحقّ کلّ إنسانٍ.
تمّ تدوین هذه المقالة وفق منهج بحثٍ عقلیٍّ - روائیٍّ والهدف منها بیان الحقائق المرتبطة بالمواضیع المشار إلیها أعلاه، ومن هذا المنطلق سعى الباحث إلى تسلیط الضوء علیها فی إطار تصویرٍ واضحٍ لمعالمها بغیة بیانها بأفضل وجهٍ للقرّاء الکرام. من جملة الاستنتاجات التی توصّل إلیها الباحث أنّ کتاب أعمال الإنسان هو شیءٌ مادّیٌّ حسب دلالة بعض الأدلّة النقلیة، وأنّ "تطایر الکتب" یعنی تشتّتها وانتشارها، وأنّ صدور الحکم النهائی منوطٌ بالله تعالى وبعض المحاسبین الآخرین.
کلمات مفتاحیة: کتاب الأعمال، تطایر الکتب، أعمال الإنسان، السرائر، الحکم، القضاء
معنى أفضیلة الإمام على غیره ونطاق هذه الأفضلیة برؤیة علماء الکلام
محمّد حسین فاریاب
الملخّص:
حسب مبادئ الفکر الشیعی وآراء الکثیر من أهل السنّة والجماعة، فإنّ أفضلیة الإمام على غیره تعدّ شرطاً أساسیاً لإمامته؛ وهذه المسألة قد کانت مدار بحثٍ ونقاشٍ بین العلماء شیعةً وسنّةً على مرّ التأریخ الإسلامی. الهدف من تدوین هذه المقالة هو إجراء دراسةٍ موجزةٍ حول معنى الأفضلیة من وجهة نظر علماء الکلام، وقد تمّ تدوینها على أساس منهج بحثٍ مکتبیٍّ.
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ مسألة أفضلیة الإمام على غیره والتی تعتبر فی الحقیقة مثالاً لمعنى الأفضلیة الحقیقی تعتبر واحدةً من المسائل المحوریة والأساسیة على صعید المباحث المتعلّقة بها، ومن هذا المنطلق قام الباحث ببیان معناها من وجهة نظر علماء الکلام والتی نستلهم منها آراءهم أیضاً حول نطاقها. أمّا أهمّ نتائج البحث فقد أثبتت أنّ علماء الکلام السنّة لم یعیروا أهمیةً کبیرةً لهذا الموضوع، فی حین أنّ علماء الکلام الشیعة بادروا إلى طرح الکثیر من المباحث حولها.
کلمات مفتاحیة: الأفضلیة، معنى الأفضلیة، نطاق الأفضلیة، الإمام، علماء الکلام
تنصیب الإمام المعصوم من قبل الله تعالى فی فکر المحدّثین الإمامیین المتقدّمین وعلى رأسهم الشیخ الصدوق
السیّد أحمد الحسینی
الملخّص:
الهدف من تدوین هذه المقالة هو بیان آراء المحدّثین المتقدّمین من الشیعة حول اعتبار الإمامة منصباً إلهیاً من منطلق أنّ الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) قد نصّبوا من قبل الله عزّ وجلّ، فعلى الرغم من أنّ هذا الأمر یعدّ من المعتقدات الأساسیة فی مذهب أتباع أهل البیت (علیهم السلام)، لکنّ البعض انتقده بزعم أنّه ثمرةٌ لاستنتاجاتٍ عقلیةٍ طرحها علماء الکلام فی مدرسة بغداد الفکریة، حیث تعامل هؤلاء العلماء مع مختلف المسائل العقائدیة وفق نزعاتٍ عقلیةٍ؛ لذلک قال المعترضون علیهم بأنّ المحدّثین المتقدّمین حتّى أوائل القرن الخامس الهجری کانوا یعتقدون بأنّ الإمامة منصبٌ یمنح للإمام فی شروطٍ دنیویةٍ ولیست سماویةً، لذلک قالوا إنّه من الغلوّ بمکانٍ اعتبارها منصباً إلهیاً.
تمّ تدوین هذه المقالة وفق منهج بحثٍ توصیفیٍّ - تحلیلیٍّ والهدف منها إثبات أنّ غالبیة المحدّثین المتقدّمین وبمن فیهم کبار علماء الکلام فی مدرسة بغداد کانوا یعتقدون بأنّ الإمامة منصبٌ إلهیٌّ، بمعنى أنّ الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) منصّبون من قبل الله عزّ وجلّ لتولّی هذا المقام الدینی السیاسی.
کلمات مفتاحیة: الإمامة، الإمامة منصب إلهی، الإمامة السیاسیة، الإمامة الدینیة
الولایة التکوینیة لأهل البیت (علیهم السلام) ومدى نطاقها
السیّد محمّد حسن صالح
الملخّص:
الولایة التکوینیة تعدّ واحدةّ من أهمّ الشؤون المرتبطة بأهل البیت (علیهم السلام)، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض المعاصرین أنکروا قدرة الکائنات فی التصرّف بالأمور التکوینیة معتبرین ذلک غلوّاً وخروجاً عن دائرة التوحید، فی حین أنّ الکثیر من العلماء ذهبوا إلى العکس من ذلک بعد تبنّیهم مبدأ الولایة التکوینیة وتأکیدهم على عدم استلزام هذه العقیدة للشرک أو الغلوّ. وهناک من ضیّق نطاقه هذه الولایة، بینما ذهب آخرون إلى توسیع نطاقها إلى أبعد الحدود واعتبروها تعنی التدبیر لشؤون العالم بأسره.
تمّ تدوین هذه المقالة وفق منهج بحثٍ توصیفیٍّ - تحلیلیٍّ عن طریق جمع المعلومات بأسلوبٍ مکتبیٍّ، حیث ذکر الباحث أهمّ الأدلّة التی استند إلیها أصحاب الآراء الثلاثة المشار إلیها أعلاه ومن ثمّ بادر إلى نقدها وتحلیلها، وأهمّ النتائج التی توصّل إلیها تؤکّد على أنّ الولایة التکوینیة تعنی التصرّف بعالم الوجود فی جملته، وأنّها حقیقةٌ یمکن توضیح مبادئها وتبنّیها فی رحاب التوحید فی الأفعال کما یمکن إثباتها اعتماداً على مختلف الأدلّة النقلیة. ولکن مع ذلک لم یثبت تصرّف أهل البیت (علیهم السلام) بالکون بشکلٍ یفوق مقام الثبوت والإمکان، لذا لیس من شأنهم الخلق والرزق فی عالم الوجود.
کلمات مفتاحیة: الولایة التکوینیة، الولایة الکلّیة، التوحید فی الأفعال، التفویض، الغلوّ
دراسةٌ تحلیلیةٌ حول منشأ الولایة التکوینیة ونطاقها وکیفیة إعمالها على ضوء أحادیث کتاب "الکافی"
السیّد محسن سجّادیان / محمّد حسین فاریاب
الملخّص:
لا ریب فی أنّ الولایة التکوینیة بشتّى جوانبها تعدّ واحدةً من أهمّ المسائل المطروحة للبحث حول إمامة المعصومین (علیهم السلام)، وعلى الرغم من تدوین العدید من الکتب والمقالات حول هذا الموضوع فی الآونة الأخیرة، ولکن نظراً لأهمّیته وأهمّیة دراسة وتحلیل الأدلّة النقلیة والحدیثیة المرتبطة به، فمن الحریّ بنا تسلیط الضوء علیه طبقاً لما روی فی کتاب "الکافی".
منهج البحث المتّبع فی هذه المقالة توصیفیٌّ - تحلیلیٌّ والهدف منها بیان منشأ الولایة التکوینیة ونطاقها وکیفیة إعمالها من قبل الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) على ضوء ما روی فی کتاب "الکافی". وأمّا أهمّ النتائج التی توصّل إلیها الباحثان فیمکن تلخیصها کما یلی: معرفة الإمام المعصوم (علیه السلام) بالاسم الأعظم، امتلاکه علم الکتاب، الأسباب التی جعلته أهلاً للولایة، ولایته تعمّ مجالات عدیدة، له القدرة على إعمال ولایته التکوینیة متى ما شاء، وأحیاناً یعملها استجابةً لرغبة الآخرین.
کلمات مفتاحیة: الولایة، الولایة التکوینیة، منشأ الولایة التکوینیة، نطاق الولایة، کیفیة إعمال الولایة التکوینیة، کتاب الکافی
الآراء الکلامیة لمحدّثی سیستان منذ باکورة ظهورها وحتّى نهایة القرن الخامس الهجری
محمّد رضا بیری
الملخّص:
مدینة سیستان تعتبر واحدةً من المناطق الهامّة التی قطنها أرباب الحدیث فی القرون الهجریة الأولى، فبعض هؤلاء العلماء دوّنوا مؤلّفاتٍ فی علم الکلام وبعضهم دوّنوا مؤلّفاتٍ فی علم الحدیث حیث نقلوا الأحادیث على أساس رؤیةٍ کلامیةٍ عقائدیةٍ. قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة وتحلیل المسیرة التأریخیة للفکر الکلامی الذی تبنّاه أرباب الحدیث فی مدینة سیستان منذ باکورة ظهورها وحتّى نهایة القرن الخامس الهجری، وقد أثبتت نتائج هذه الدراسة أنّ أرباب الحدیث فی سیستان لم یتّفقوا على آراء کلامیة منسجمة إبّان القرنین الأوّل والثانی، ولکن فی القرن الثالث تطوّرت هذه المدرسة العقائدیة بحضور عثمان بن سعید الدارمی وأبی داوود السجستانی، وبلغت ذروتها فی النشاطات الکلامیة خلال القرن الرابع إثر جهود أبی سلیمان الخطابی البستی وابن أبی داوود، وشیئاً فشیئاً تطوّرت أکثر فی القرن الخامس بفضل جهود أبی نصر السجزی.
منهج البحث المعتمد فی هذه المقالة توصیفیٌّ - تحلیلیٌّ، حیث سلّط الباحث الضوء فی البدایة على مختلف المصادر الکلامیة والتأریخیة والرجالیة والحدیثیة، ومن ثمّ تطرّق إلى تحلیل وتقییم النتائج التی توصّل إلیها بهدف استکشاف ماهیة التیّارات الفکریة لأهل الحدیث فی مدینة سیستان إبّان الفترة المذکورة.
کلمات مفتاحیة: سیستان، أهل الحدیث، الفکر الکلامی، الآثار الکلامیة، الجه