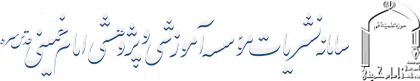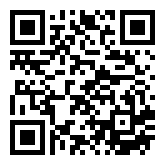المحتویات
Article data in English (انگلیسی)
بحثٌ فی مفهوم الولایة وبیان نطاقها آیة الله العلامة محمّدتقی مصباح
الخلاصة:
ورد مصطلح "الولایة" ومشتقّاته فی القرآن الکریم 233 مرّةً، وهذه المشتقّات جاءت تارةً فی إطار مشترکاتٍ لفظیّةٍ، وفی إطار مشترکاتٍ معنویّةٍ تارةً أُخرى، وأحیاناً کانت لها معانٍ حقیقیةٌ، وأحیاناً أُخرى کانت لها معانٍ مجازیةٌ.
وإذا کانت هناک علاقةٌ وثیقةٌ بین کائنین لدرجة عدم إمکان الفصل بینهما، أو کان هناک تأثیرٌ متبادلٌ بینهما أو مع غیرهما؛ یُطلق على ذلک اصطلاح "ولایة".
أمّا الولایة الإلهیة فهی على قسمین، تکوینی وتشریعی، فالقسم الأوّل یعنی التصرّفات العامّة فی جمیع الکائنات ویطلق علیه اصطلاح "الولایة التکوینیة العامّة". والقسم الثانی یتجسّد فی أفعال أولیاء الله تعالى والمقرّبین منه ویطلق علیه اصطلاح "الولایة الخاصّة التکوینیة" أو "الولایة التشریعیة" ویعنی التصرّف فی الشؤون الاجتماعیة والاعتباریة والتقنینیة، أی طرح برنامج عملٍ وتشریعٍ کان فی بادئ الأمر بید الله تعالى ومن ثمّ أوکله إلى خلفائه بغیة هدایة الناس.
إنّ القرب إلى الله تعالى هو قربٌ اکتسابیٌّ یتحقّق فی إطار اتّباع أوامره جلّ وعلا، وفیه یوکل العباد المؤمنون شؤونهم إلیه تعالى ویتوکّلون علیه. فالمقرّبون یتمتّعون بتقوى الله ویجتنبون المعاصی.
مفردات البحث: القرب إلى الله تعالى، التوکّل، الولایة، الولایة التکوینیة العامّة، الولایة التکوینیة الخاصّة، الولایة التشریعیة
العائلة المثالیة فی فکر الإمام علیّ بن الحسین "السجّاد" (ع) سعید مقدّم
الخلاصة:
هناک مخاطر وأضرار کثیرة قد أزّمت أوضاع الکیان العائلی فی العقود الأخیرة، لذلک من الضروری بناء عائلةٍ دینیةٍ مثالیةٍ من أجل مواجهة المخاطر الحدیثة. قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة واقع العائلة المثالیة فی فکر الإمام علیّ بن الحسین السجّاد (ع)، اعتماداً على منهج تحلیل النصّ. ومن الأهداف التی یسعى الباحث لتحقیقها، بناء أُسرةٍ استناداً إلى میزات خاصّة وعبر طرح مناهج من شأنها تحقیق ذلک.
إنّ العائلة المثالیة رغم أنّها تتکوّن استجابةً للحاجة الجنسیة، إلا أنّها تمهّد الأرضیة المناسبة لتربیة إنسانٍ موحّدٍ وتأسیس مجتمعٍ مثالیٍّ، کونها تتمتّع بمبادئ توحیدیة وتطرح میزات ومناهج نابعة من واقع الوحی السماوی.
مفردات البحث: العائلة المثالیة، فکر الإمام السجّاد (ع)، الخصائص، المناهج.
أسباب ظهور الفِتَن فی الحکومة الإسلامیة وسبُل النجاة منها فی رحاب کلام أمیر المؤمنین (ع) عارفة خوروش – حمید رضا نریمانی
الخلاصة:
إنّ خلق الفِتَن والفوضى وترویجها من قبل الأعداء کانت من أهمّ الأزمات الاجتماعیة فی جمیع المجتمعات، ولا سیّما المجتمعات الإسلامیة. وعند عدم تشخیصها وعدم التعامل معها، قد تؤدّی إلى انهیار نظامٍ وتعرّض الأُمّة إلى الکثیر من الحوادث.
الهدف من تدوین هذه المقالة هو دراسة جذور الفِتَن ومعرفة أسباب نشؤوئها فی رحاب الحکومة الإسلامیة، وبالتالی طرح مناهج للنجاة منها فی رحاب الکلام القیّم لأمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب (ع) وتصنیفه وتحلیله کما ورد فی نهج البلاغة؛ حیث قام الباحثان بتحلیل مفاهیم نهج البلاغة اعتماداً على فهرست هذا الکتاب وتقسیماته التی طرحها الأستاذ الدشتی فی ترجمته.
وقد أشارت نتائج البحث إلى أنّ أهمّ أسباب رواج الفِتَن برأی الإمام علی (ع) هی: خلق الشبهات وترویجها من قبل الأعداء ومزج الحقّ بالباطل وعدم تشخیص الفِتَن بشکلٍ صحیحٍ. وأهمّ أسباب للنجاة منها هی: الطاعة المحضة للقائد واجتناب أیّ نوعٍ من التفرقة والتشتّت.
مفردات البحث: نهج البلاغة، الحکومة الإسلامیة، الفتنة، إطاعة القائد، الوحدة.
معاییر الإقناع الفکری للمخاطب وضوابطه برؤیةٍ قرآنیة
محمّد کاظم شاکر – حسین حاجی بور
الخلاصة:
إنّ الإقناع هو عملیةٌ ارتباطیةٌ هدفها الأساسی نقل المضمون إلى المخاطب فی إطارٍ مؤثّرٍ. وطبقاً للتعاریف والتوضیحات والأسالیب الإقناعیة الموجودة، فإنّ التأثیر الإقناعی فی الکثیر من الموارد یتمّ فی إطارٍ إجباریٍّ وخداعٍ إقناعیٍّ. ولکنّ الآیات والتعالیم القرآنیة رغم تأییدها لعملیة الإقناع وتشجیعها على اتّباع أسالیب إقناعیة مؤثّرة فی نقل الفکر إلى الآخرین، إلا أنّها لا تؤیّد الخداع الإقناعی مطلقاً، لذلک یمکن تحصیل ضوابط إقناعیة من خلال طرح أسئلةٍ من القرآن الکریم.
أُسلوب البحث المتّبع فی هذه المقالة مرتکزٌ على أساس باطن الدین، ویتطرّق الباحث فیها إلى بیان أهمّ ضوابط کلّ نشاطٍ إقناعیٍّ وتحلیل التعالیم القرآنیة فی إطار منهجین، أحدهما تفسیریّ والآخر کلامیّ.
وبالطبع فإنّ موضوعی "حریة الفکر" و"استخدام الوسائل الصحیحة" یعدّان من أهمّ المعاییر فی کلّ عملیةٍ إقناعیةٍ. ولکن الاعتماد على وسائل غیر مشروعةٍ واتّباع مناهج تسلب حریة الفکر والقدرة على اتّخاذ القرار من المخاطب، تعتبر نوعاً من الخداع الاجتماعی وعملاً غیر مشروعٍ. والقرآن الکریم بدوره حذّر مخاطبیه من تأثیر الخداع الإقناعی.
مفردات البحث: الإقناع، حریة الفکر، استخدام الوسیلة، ضوابط الإقناع.
مدخلٌ إلى العلاقات الإسلامیة فی المجتمع الدینی (من العلم الدینی إلى علم الارتباطات الدینیة) کریم خان محمّدی – داوود رحیمی سجاسی
الخلاصة:
المدعى الذی تطرحه هذه المقالة هو أنّ العلم الحدیث - حسب النقد الذی یورد علیه - لو کان یتمتّع بشخصیة ثقافیة وتأریخیة، وأنّه فی معزل عن العقل والوحی؛ فإنّ العلم الدینی یمکن طرحه استناداً إلى مرجعیة العقل والوحی والتجربة والتجدید الثقافی والحضاری والتأریخ الإسلامی. وکذلک إذا کان العلم الدینی ممکن التحقّق فإنّ علم الارتباطات الدینیة هو الآخر سیکون قابلاً للتأمّل. وفی النهایة، فإنّ تحقّق العلم الدینی وعلم الارتباطات الدینی یؤدّی إلى تمهید الأرضیة لنشوء مجتمعٍ دینیٍّ.
ومن النتائج المتحصّلة فی هذا البحث، ارتکاز تحقّق علم الارتباطات الدینیة على إنتاج العلم الدینی، وارتکاز تحقّق المجتمع الدینی على علم الارتباطات الدینیة والعلم الدینی. وقد استُند إلى سیرة الرسول الأکرم (ص) الارتباطیة کأُنموذجٍ صریحٍ للارتباطات الدینیة بین الأفراد، حیث لها القابلیة على استخراج أُصول علم الارتباطات الدینیة ومبادئه. وقد اعتمد الباحثان على أُسلوب نقض الهیکل والبحث النقضی، وقد تمّ جمع المعطیات بشکلٍ وثائقیٍّ.
مفردات البحث: العلم الحدیث، العلم الإیجابی، العلم الحدیث المتدنّی، علم الارتباطات، العلم الدینی، الارتباطات الدینیة.
دراسةٌ لمدى فاعلیة التبلیغ التقلیدی للدین فی المجتمع المعاصر
روح الله عباس زاده
الخلاصة:
فی المجتمع المعاصر الذی یشهد ظهور تقنیات حدیثة فی مجال الاتّصالات، فإنّ تشخیص الأسالیب التبلیغیة المؤثّرة یعدّ خطوةً هامّةً فی مجال تبلیغ المعارف الدینیة وتأصیل المبادئ الدینیة وتنمیة واقع الإیمان فی المجتمع. إنّ دراسة میزات منهج التبلیغ التقلیدی المتعارف فی الحوزات العلمیة والذی یرتکز على أساس المقابلة وجهاً لوجهٍ وتقییم مدى فاعلیته، من شأنه تمهید الطریق لتحقیق هذا الهدف. فهل أنّ هذا المنهج التبلیغی لا زال مؤثّراً رغم التغییرات الهیکلیة التی طرأت على المجتمع؟ وما هی نتائجه للمجتمع المعاصر؟
یقوم الباحث فی هذه المقالة بدراسة الخصائص الفردیة والاجتماعیة لهذا المنهج التبلیغی فی المجتمع المعاصر. فدراسة هذه الخصائص ومقارنتها بالمناهج الإعلامیة الحدیثة تعتبر ضروریةً لإثبات مدى نجاعتها. وأُسلوب البحث هو وثائقیٌّ میدانیٌّ، حیث أثبتت النتائج أنّ التبلیغ التقلیدی للدین لا زال فاعلاً فی مختلف المجالات، لذا لا بدّ من أن یکون محوراً للإعلام الدینی إلى جانب الاستفادة من وسائل الإعلام الحدیثة.
مفردات البحث: الدین، التبلیغ التقلیدی، الفاعلیة، التقبّل الثقافی.
الزیّ الإسلامی لطالبات الجامعات، معرفة جذور أسباب إهماله، وبیان سبل الحل
سیف الله فضل اللهی
الخلاصة:
یتطرّق الباحث فی هذه المقالة إلى تشخیص أسباب عدم اهتمام طالبات الجامعات بالزیّ الإسلامی وبیان سبُل ترویجه اعتماداً على آرائهنّ، حیث اتّبع أُسلوباً نظریاً استقرائیاً، ونطاق البحث هو طالبات جامعة قم. فقد تمّ اختیار عیّنةٍ مقدارها 262 طالبةً بطریقةٍ عشوائیةٍ وفق جدول بیانات مورغان وکرجسی، وجمعت المعلومات حسب استبیانین شملا 18 استفساراً فی إطار لیکرت بأساسٍ بلغ 0,78 و17 طریق حلٍّ من نوع تراصفٍ رتبیٍّ بأساسٍ بلغ 0,89 استناداً إلى ألفا کرانباخ. وقد أثبتت نتائج تحلیل المعلومات ما یلی: إنّ العوامل الثقافیة العقائدیة لها تأثیرٌ معتبرٌ إیجابیٌّ على عدم اکتراث الطالبات بالزیّ الإسلامی. أمّا العوامل البیئیة النفسیة، والثقافیة الاجتماعیة، والسیاسیة الاجتماعیة، فبالرغم من اکتسابها درجةً أعلا من الحدّ المتوسط المتوقّع، فلیس لها تأثیرٌ معتبرٌ وإیجابیٌّ. ولا یوجد تأثیرٌ لمختلف العوامل فی عدم اهتمام الطالبات بالزیّ الإسلامی.
ومن الأولویات التی من شأنها ترویج الزیّ الإسلامی بین طالبات الجامعات ما یلی: البرمجة لنوع الثیاب فی الفراغ الثقافی والتربوی الحاصل فی المدارس والجامعات، تنویر الأذهان العامّة ولا سیّما أذهان طالبات الجامعات بالنسبة إلى عواقب السفور الوخیمة، ترسیخ الروحیة الدینیة فی التربیة بغیة الالتزام بالقیَم الاجتماعیة.
مفردات البحث: الزیّ الإسلامی، طالبات الجامعات، الجامعات، سبُل الترویج، أسباب عدم الاهتمام.
دراسةٌ نقدیّةٌ للأفکار التی طرحها المفکّر المغربیّ المعاصر طه عبد الرحمن
هادی بیکی ملک آباد
الخلاصة:
یتطرّق الباحث فی هذه المقالة إلى دراسة ونقد المشروع الفکری للمفکّر المغربیّ المعاصر "طه عبد الرحمن". وقد اتّبع الباحث أُنموذجاً خاصّاً فی طرح الفکر لتحقیق هدف المقالة، فأوّلاً تحدّث عن الخلفیّات الفکریة والتربویة لطه عبد الرحمن ثمّ ذکر أُسس منظومته الفکریة، أی مبادئه الوجودیة والمعرفیة والإنسانیة. وبعد ذلک قام بدراسة المقولات الأساسیة التی یرتکز علیها فکره، کالدین والحداثة والتراث والفلسفة الاجتماعیة، وذلک فی إطار أُسلوبٍ وثائقیٍّ تحلیلیٍّ.
مفردات البحث: الوجودیة، المعرفیة، الإنسانیة، الأخلاق، الدین، الحداثة