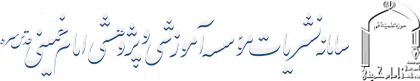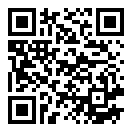الملخّص
Article data in English (انگلیسی)
البرنامج الیومی للشیعة الحقیقیین (2)
آیة الله العلامة محمّد تقی مصباح
الملخّص:
تتضمّن هذه المقالة شرحاً ووصفاً للسلوکیات الیومیة الخاصّة بالشیعة الحقیقیین على ضوء ما روی عن الإمام علی (علیه السلام)، فقد أکّد على أنّ أبدانهم نحیفةٌ لشدّة خشیتهم من الله تعالى.
لا شکّ فی أنّ الحزن فی حدود المعقول، یوجد لدى الإنسان دافعاً للسیر نحو الکمال المنشود ویساعد على منحه الطمأنینة؛ بینما عدم مبالاته یسفر عن زوال شعوره بالمسؤولیة ویحرمه من وضع برنامجٍ مناسبٍ لتحقیق الأهداف المرجوّة، إذ کلّ إنسانٍ غیر مبالٍ ولا یشعر بالحزن، عادةً ما یقبل على تناول شتّى أنواع الطعام بشهیةٍ کبیرةٍ فیتنامى بدنه حتّى یبلغ درجة السمنة، وبالتالی لا یفکر إلا بالمأکل والراحة. طبعاً نحن لا نقصد هنا الإعراض التامّ عن کلّ شیءٍ، فالخشیة التی تکتنف الإنسان جرّاء حبّه للحیاة لیست ذمیمةً، فهی تساعده على الوقایة من المخاطر المحدقة به، ولکنّ الشعور بالخشیة من الله عزّ وجلّ یسلب منه الراحة والطمأنینة؛ وهذا الإنسان الخائف من العذاب الإلهی حتّى وإن کان طلق الوجه وبشوشاً مع الناس وقادراً على وضع حلولٍ لمشاکلهم، إلا أنّه فی الحین ذاته یبقى فی خشیةٍ من المصیر.
بما أنّ المتّقین والشیعة الحقیقیین هدفهم القیام بأعمال لائقة وحسنة، ولا یکتفون بأداء القلیل من الأعمال الصالحة؛ فإنّهم لا یعبؤون کثیراً بالدنیا وملذّاتها وزخرفها، بل هم قلقون من قلّة الزاد وطول السفر.
التعالیم القرآنیة تؤکّد على أنّ النِّعم والخلقیات والسلوکیات الحمیدة الدالّة على الکمال، کلّها منسوبةٌ إلى الله سبحانه وتعالى؛ بینما المساوئ والنواقص والذنوب کلّها ناجمةٌ عن ضعف النفس الإنسانیة وقصورها؛ وعلى هذا الأساس یجب على الإنسان فی جمیع الأحوال أن یفکّر بعاقبته، وإذا أراد تهذیب نفسه معنویاً، فلا بدّ له من محاسبتها باستمرارٍ.
کلمات مفتاحیة: الخشیة، الحرمان من الأنس بالمعبود، التکبّر
تقییم تربوی: مکانة التقییم فی تعلیم القیم
مهناز حاج غلام رضائی / السیّد حمید رضا علوی
الملخّص:
التقییم التربوی ذو أهمیةٍ بالغةٍ حاله حال التقییم الدراسی، لذا یجب وأن یُعتمد فی جمیع النشاطات التعلیمیة الخاصّة بالمسائل التربویة، وینبغی على أساسه تحدید ما إن کان النظام التعلیمی متناسقاً مع الهدف المنشود أو لا.
الهدف من تدوین هذه المقالة استکشاف أسالیب التقییم التربوی المناسبة، وقد اعتمدت الباحثة على منهج بحثٍ وصفی تحلیلی اعتماداً على المعطیات المکتبیة والنظریة، کما استفادت من النتائج التی توصّل إلیها سائر الباحثین على هذا الصعید. وأمّا المعطیات التی تحقّقت فقد دلّت على وجود أربعة عشر أسلوباً مناسباً للتقییم، أربعةٌ منها مستوحاة من آراء العلماء التربویین، وعشرةٌ طرحت على ضوء بحوثٍ علمیةٍ؛ لذا یمکن الاعتماد علیها على صعید تقییم التعالیم التربویة وکذلک من شأنها أن تتّبع کمنهجٍ من قبل التربویین الرسمیین وغیر الرسمیین لأجل تقییم شخصیات المتعلّمین والتعرّف على مدى رسوخ القیم التی تمّ تعلیمها لهم فی أنفسهم؛ ومن هذا المنطلق یتسنّى لهم تقییم مدى نجاح أو فشل برامجهم التربویة، وبالتالی تتمهّد الأرضیة المناسبة لهم لإعادة النظر فی الأسالیب التربویة ومختلف مراحل العملیة التعلیمیة.
کلمات مفتاحیة: التقییم، التقییم التربوی، التعالیم التربویة، تأصیل القیم
الالتزام بالمعتقدات الدینیة ودوره فی البهجة وسلامة النفس
زینت السادات الحسینی / فائزة ناطقی
الملخّص:
الهدف من تدوین هذه المقالة هو دراسة وتحلیل دور الالتزام بالمعتقدات الدینیة فی سلامة النفس وبهجتها بین طالبات فرع العلوم التربویة فی جامعة آزاد الإسلامیة بمدینة أراک، وقد اتّبع الباحثون أسلوب بحثٍ وصفی مترابطٍ، ونطاق البحث شمل 144 طالبةً فی الفرع المذکور على مستویات البکالوریوس والماجستیر والدکتوراه، وعیّنة البحث اقتصرت على 105 طالباتٍ تمّ تصنیفهنّ حسب جدول مورغان بشکلٍ عشوائی. ولأجل جمع المعلومات، اعتمد الباحثون على ثلاثة استبیاناتٍ هی استبیان الخاص بالبهجة المطروح من قبل أوکسفورد، واستبیان السلامة العامّة، واستبیان دینی؛ وقد بلغت درجة الثبوت فیها على الترتیب کما یلی: 943.0، 905.0 و 863.0. على أساس جدول الانحدار. ولأجل تحلیل معطیات البحث اعتمد الباحثون على الأسالیب الإحصائیة التوصیفیة والاستدلالیة بمستوى تحلیل التباین الأحادی "ANOVA" ومستوى الترابط الثابت والمتغیّر والمستقلّ، حیث أثبتت النتائج وجود ارتباطٍ دالٍّ بین العمل بالمعتقدات الدینیة وبین مدى البهجة والسلامة النفسیة لطالبات الجامعات بحیث إنّ الالتزام بها یضمن لهنّ السلامة النفسیة وتحقیق البهجة فی الحیاة، فهذا الالتزام له دورٌ کبیرٌ فیما ذکر.
کلمات مفتاحیة: الالتزام بالمعتقدات الدینیة، البهجة، السلامة النفسیة
التربیة الأخلاقیة فی سنّ الطفولة وأهمّ العوامل المؤثّرة علیها: منهج نظری لوضع برامج تربویة
حسن نجفی / محمّد حسن محمّدی
الملخّص:
التربیة الأخلاقیة تعتبر واحدةً من أهمّ النشاطات التربویة ویراد منها تحقیق معرفةٍ وإثارة المشاعر بغیة التقلیل من الرذائل والتحذیر من ارتکابها إلى جانب مراقبة النفس وتربیتها بشکلٍ ینسجم مع مقتضیات الفضائل کی تصبح ملکةً فی باطن الإنسان. من المؤکّد أنّ التعرّف على الکیفیة الصائبة للتربیة الأخلاقیة فی سنّ الطفولة واستکشاف مختلف العوامل المؤثّرة فیها، من شأنهما إعانتنا على وضع منهجٍ نظری یتمّ على أساسه إیجاد نظمٍ للبرامج التربویة؛ وعلى هذا الأساس تمّ تدوین المقالة بأسلوب بحثٍ وصفی تحلیلی.
نتائج البحث دلّت على أنّ التربیة الأخلاقیة فی سنّ الطفولة یجب وأن تکون هادفةً ومتقوّمةً على أفضل الأسالیب المؤثّرة، کما یجب فیها الأخذ بنظر الاعتبار مختلف العقبات والمشاکل، وینبغی أن تنتظم وتطبّق على ضوء ثلاثة أبعادٍ، معرفیة وعاطفیة وعملیة. وتجدر الإشارة هنا إلى وجود بعض العوامل المؤثّرة الأخرى على صعید النظام التربوی المشار إلیه، مثل الوراثة والبیئة الاجتماعیة، کالأسرة والمدرسة والأقران ووسائل الإعلام الافتراضیة وغیر الافتراضیة وشتّى الظروف الجغرافیة.
کلمات مفتاحیة: سنّ الطفولة، کیفیة التربیة الأخلاقیة، العوامل المؤثّرة على التربیة الأخلاقیة، وضع برامج تربویة
نظرةٌ على فلسفة تربیة الأطفال النوابغ: المبانی والأهداف والأصول
مجید خاری آرانی / أکبر رهنما / رسول برخوردار
الملخّص:
الهدف من تدوین هذه المقالة هو دراسة وتحلیل فلسفة تربیة الأطفال النوابغ من حیث المبانی والأهداف والأصول، وهی عبارةٌ عن دراسةٍ نظریةٍ دوّنت بأسلوب بحثٍ تحلیلی وثائقی، حیث جمعت المعلومات فیها اعتماداً على المصادر المکتبیة، وأشارت النتائج إلى أنّ التربیة لها تأثیرٌ بالغٌ على هذه الشریحة من الأطفال.
یمکن تلخیص أهمّ المبانی التربویة للأطفال النوابغ بما یلی: کرامة الإنسان، امتلاک بنی آدم فطرة مشترکة ومیزات شخصیة مختلفة، التخییر فی الأعمال، إقامة العدل باعتباره أهمّ القیم الاجتماعیة، الإحسان متمّم لمبدأ العدل.
وأهمّ الأهداف التربویة تتلخّص بما یلی: بلوغ مرتبة الفلاح، معرفة النفس، تنمیة روح الاحترام لدى الإنسان والرفع من شأنها، التقلیص من الأضرار التی تعترض طریق النمو من خلال التدخّل المبکّر، تنمیة القابلیات.
وأمّا أهمّ الأصول التربویة، فهی بشکلٍ مجملٍ: تربیة النفس على أساس مبدأ عزّة النفس، تنمیة الإبداع، النشاط، الإیثار.
کلمات مفتاحیة: فلسفة التعلیم والتربیة، الأطفال النوابغ، المبانی، الأهداف، الأصول
السبُل المناسبة لتعلیم الأطفال معنى "الموت" على ضوء القرآن والحدیث
مریم عشوری / طیبة ماهروزاده
الملخّص:
الموت یعتبر حدثاً عظیماً فی حیاة البشر، فهو یعنی الانتقال من دارٍ إلى أخرى، والإنسان عادةً ما لا یرغب فی حلوله؛ ولکن رغم ذلک یجب علیه عاجلاً أم آجلاً أن یحلّ بساحته، فهو المصیر المحتوم الذی لا مردّ منه؛ وعلى هذا الأساس تقتضی الضرورة الاعتماد على الأسالیب التربویة الصائبة لأجل بیان معناه للأطفال، فهذا الأمر بمثابة وضع حجر الأساس للفرد والمجتمع. یشار هنا إلى أنّ الأسالیب التربویة الصائبة والمتقوّمة على التفکّر والأصول الفلسفیة الإسلامیة، یجب وأن تتناسب مع الفئات السنّیة للأطفال.
تمّ تدوین هذه المقالة بأسلوب بحثٍ وصفی تحلیلی بهدف طرح سبُلٍ ناجعةٍ لبیان المقصود من مفهوم "الموت" للأطفال، وذلک بالاعتماد على القرآن الکریم والمصادر الدینیة وعلى ضوء برهان "الخلف"؛ وأمّا النتائج فقد دلّت على أنّ تعلیم هذا المفهوم للأطفال یقتضی فی الخطوة الأولى عدم تسلیط الضوء على القضایا التی تتعلّق به بشکلٍ مباشرٍ وضرورة تجاوزها، وفی الخطوة الثانیة ینبغی الاعتماد على بعض الأسالیب لبیانه مثل التشبیه وبیان دورة الحیاة فی الطبیعة من بدایتها إلى نهایتها.
کلمات مفتاحیة: الموت، السبیل المناسب، التعلیم، تجاوز المعنى، القصّة، التشبیه
العقبات الکامنة فی تدوین البحوث العلمیة فی الجامعات: دراسةٌ مصداقیةٌ مقارنةٌ بمحوریة جامعتی قم وآزاد
سیف الله فضل الله قمشی
الملخّص:
من المؤکّد أنّ عملیة البحث والإنتاج العلمی هی الرسالة الأولى للجامعات، وتعتبر الخلفیة الأساسیة لتنمیة المجتمعات من شتّى النواحی واستقراراها فی العصر الراهن، لذا فالضرورة تقتضی إجراء دراسةٍ واقعیةٍ حول أهمّ العقبات الکامنة فی هذه الطریق ولا سیّما بالنسبة إلى طلاب الجامعات، وهذه الدراسة من شأنها تیسیر عملیة البحث العلمی الناجحة فی المراکز الجامعیة. الهدف من تدوین المقالة هو تسلیط الضوء على أهمّ العوامل التی تعرقل عملیة البحث العلمی فی الجامعات، حیث قام الباحث فیها بإجراء مقارنةٍ بین جامعتی قم وآزاد (فرع مدینة قم)، واعتمد على أسلوب بحثٍ وصفی استقرائی. نطاق البحث شمل جمیع طلاب الجامعتین وتمّ اختیار ما مقداره 355 طالباً بشکلٍ عشوائی کعینةٍ للبحث.
وأمّا نتائج البحث فقد دلّت على ما یلی:
1) الدور الرادع للعوامل المحفّزة، کیفیة تقدیم الخدمات البحثیة، القضایا الإداریة والبنیویة والثقافیة، العوامل الشخصیة التقنیة والتخصّصیة. هذه الأمور لها تأثیرٌ على بحوث طلاب جامعة آزاد أکثر من تأثیرها على طلاب جامعة قم، والنسبة الإحصائیة بلغت ما مقداره 0,99 بالمئة و 1 بالمئة.
2) لم یُلاحظ اختلافٌ معتبرٌ بین التسلسل الرتبی لطلاب الجامعتین بالنسبة إلى العوامل الرادعة فی البحوث العلمیة.
3) أهمّ العوامل الرادعة عن البحث العلمی فی جامعة آزاد تکمن فی الشؤون الفردیة التقنیة والتخصّصیة، وفی جامعة قم تتجسّد فی مستوى تقدیم الخدمات البحثیة.
کلمات مفتاحیة: بحوث طلاب الجامعات، العوامل الرادعة، جامعة آزاد الإسلامیة، جامعة قم